في كتابه “سورية وإسرائيل: من الحرب إلى صناعة السلام”، يقترح الباحث الإسرائيلي موشيه معوز إعادة قراءة لمسار العلاقات السورية–الإسرائيلية من زاوية تبدو علمية في ظاهرها، لكنها مشبعة بفرضيات أيديولوجية تفضح عمق التناقض بين الذاكرة التاريخية والسياسة الواقعية في الشرق الأوسط.
هذا العمل، الذي يجمع بين التوثيق التاريخي والتحليل السياسي، يشكّل مرآة دقيقة، وإن كانت غير بريئة، لصورة الصراع كما رآها أحد أبناء المؤسسة الأكاديمية “الإسرائيلية”، في محاولة لتأطير الماضي ضمن سردية تبرّر الحاضر وتؤسّس لإمكانيات “سلام مُصنَّع” أكثر منه مُتفاوض عليه.
الذاكرة المؤسسة للصراع
ينطلق معوز من فرضية مركزية تقول إن الصراع بين سورية و”إسرائيل” ليس صراعا على الوجود بقدر ما هو صراع على النظام الإقليمي، فدمشق لم ترفض الاعتراف بـ”إسرائيل” لأنها تنكر واقع الدولة اليهودية، بل لأنها كانت تعتبر ذلك اعترافا بانهيار النظام العربي الذي قامت عليه شرعية ما بعد الاستقلال.
هنا تكمن أولى المفارقات التي يكشفها الكتاب، عن قصد أو من دون وعي، وهي أن الصراع بين البلدين تحوّل منذ بداياته من مسألة حدودية إلى صراع بين مشروعين؛ الأول قومي عربي يرى نفسه وارثا لشرعية التاريخ، والثاني صهيوني يسعى لانتزاع هذه الشرعية بالقوة وبدعم غربي.
غير أن معوز، في سعيه لتقديم تحليل “موضوعي”، يميل إلى إغفال البعد الكولونيالي المؤسس لـ”إسرائيل”، ويُقدّمها كفاعل سياسي يسعى للأمن والاستقرار مقابل نظام سوري “ممانع” تحركه الأيديولوجيا، وهذه المقاربة تُعيد إنتاج الفكرة الغربية الكلاسيكية عن “الشرق غير العقلاني”، وتُحوّل الصراع إلى مشكلة إدراك متبادل، لا إلى مسألة استعمارية محضة.
حرب 1948 إلى 1973: بين الجرح والرمز
يعيد معوز قراءة الحروب المتكررة بين الطرفين بوصفها مراحل في نضوج الوعي السياسي السوري، فحرب 1948 بالنسبة له لم تكن مجرد هزيمة عسكرية، بل صدمة وجودية ولّدت شعورا بالعزلة والخذلان، ثم تأتي حرب 1967 لتعمّق هذا الجرح وتحوّله إلى عقيدة، أما حرب تشرين 1973 فتمثل، في رأي الكاتب، بداية التحوّل من “حرب التحرير” إلى “حرب التوازن”.
تغفل هذه القراءة أن حرب تشرين كانت، من منظور دمشق، محاولة لاستعادة الذات العربية من داخل منطق الهزيمة، لا من خارجه، أي أنها لم تكن لحظة براغماتية بل لحظة استعادة للكرامة، ومعوز، في تفكيكه لتاريخ الصراع، يميل إلى تجريده من بعده الوجداني، محاولا إقناع القارئ بأن التغير في الموقف السوري هو نتيجة تطور عقلاني في القيادة، لا انعكاس لتحوّل اجتماعي–ثقافي أعمق في المجتمع السوري نفسه.
يختزل التحليل في لعبة مؤسساتية بين النظامين، متجاهلا التحولات الداخلية في بنية الدولة والمجتمع اللذين حملا معا إرث الهزيمة بوصفه هوية.
من الصراع إلى “صناعة السلام”
العنوان الفرعي للكتاب “من الحرب إلى صناعة السلام” ليس بريئا لغويا، فالفعل هنا ليس “بناء” السلام، بل “صناعته”، أي تحويله إلى منتج سياسي قابل للتسويق في سوق العلاقات الدولية، ويتضح هنا المنظور الذي يحكم أطروحة معوز أن السلام ليس نتيجة لتبدّل المواقف الأخلاقية أو لتصالح الذاكرات، بل لصفقة واقعية بين الأنظمة.
يُعيد معوز قراءة مرحلة مفاوضات مدريد (1991) وما تلاها بوصفها لحظة مفصلية كشفت براغماتية دمشق وانفتاحها على التفاوض، مقابل تصلّب “إسرائيلي” نابع من “الهواجس الأمنية”، لكنّ هذا التحليل يغفل توازن القوى المختل؛ فـ”إسرائيل” تفاوض من موقع المنتصر والمحتل، بينما سورية تفاوض من موقع الدولة التي تُطالب بحدودها الطبيعية (الجولان).
إن “صناعة السلام” هنا لا تُعنى ببناء الثقة بقدر ما تُعنى بإعادة إنتاج هيمنة جديدة تحت مسمى الواقعية، وهنا تتجلّى فلسفة النص فالسلام، كما يراه معوز، ليس فعلا أخلاقيا، بل أداة لتثبيت التراتبية الإقليمية التي تضمن لـ”إسرائيل” التفوق الاستراتيجي إلى أمد طويل.
السياسة بوصفها علم إدارة الخوف
في قراءته للنظام السوري، يصف معوز البنية السياسية بأنها تحكمها عقلية الأمن قبل السياسة، وهي قراءة تحمل شيئا من الصحة، لكنها تغفل أن “إسرائيل” ذاتها بُنيت على منطق الأمن الدائم، المفارقة أن كِلا النظامين السوري و”الإسرائيلي” يعيشان على إدارة الخوف؛ خوف من الانهيار في الداخل، وخوف من الإلغاء في الخارج.
لكنّ الفارق يكمن في أن “إسرائيل” استطاعت تحويل هذا الخوف إلى سياسة توسّع، بينما حوّلته سورية إلى سياسة ردع.
من هنا يمكن قراءة العقود التي تلت حرب 1973 بوصفها عقود “تجميد للصراع وليس سلاما فعليا، فالجولان ظلّ رمزا للزمن المعلّق بين الحرب واللاحرب،و بين الذاكرة والبراغماتية.
معوز يرى في هذا الجمود دليلا على فشل “النظام العربي”، لكنّ الحقيقة أعمق أنه فشل النموذج الدولي الذي أراد أن يفرض سلاما فوقيا بلا عدالة.
بين الواقعية والأخلاق السياسية
ربما القيمة الكبرى للكتاب تكمن في كشفه غير المقصود لتناقضات المقاربة “الإسرائيلية” نفسها، فحين يتحدث معوز عن ضرورة السلام، فإنه يفعل ذلك من داخل تصور استعلائي يرى أن المبادرة بيد “إسرائيل”، وأن قبول الآخر لا يكون إلا بشروطها، وهذه ليست “صناعة سلام” بل هندسة سياسية للهيمنة.
إن السلام الحقيقي، كما تُظهر التجربة “السورية”–الإسرائيلية على الأقل قبل 2024، لا يمكن أن يولد من رحم التوازنات العسكرية بل من مصالحة الذاكرات التاريخية، فالجغرافيا وحدها لا تصنع السلام، بل الوعي بها.
هنا يمكن استحضار مقولة الفيلسوف بول ريكور “الذاكرة إذا لم تُعاد تأويلها تصبح أداة للعنف”، وهذا ما ينطبق تماما على الصراع السوري–”الإسرائيلي”، فكلا الطرفين يعيش داخل ذاكرة غير مؤولة، ذاكرة صارت جزءا من الهوية، لا من التاريخ.
معوز، في سعيه للتجريد، يُسقط من تحليله هذا البعد الفلسفي للصراع، فيجعل السياسة فعلا تقنيا لا أخلاقيا، ويختزل التاريخ في تتابع لعمل المؤسسات لا في صراع رؤى عن العدالة والكرامة والسيادة.
الجولان كمرآة أخلاقية
يبقى الجولان، في نهاية المطاف، الاختبار الحقيقي لكل سرديات “السلام”، فبالنسبة لسورية، هو ليس مجرد أرض محتلة، بل رمز للذاكرة القومية وشرط لكرامة الدولة، أما بالنسبة لـ”إسرائيل”، فهو مساحة استراتيجية تُؤمّن عمقا دفاعيا وتشكّل جزءا من “إسرائيل الكبرى” التي تتوسع ببطء باسم الأمن.
في هذا التناقض تتجسد المفارقة الجوهرية التي يتغافل عنها معوز، فلا يمكن صناعة سلامٍ على أرضٍ محتلة من دون الاعتراف بجذر المأساة، فمحاولة تسويق السلام دون عدالة ليست سوى شكل من أشكال الاستعمار الرمزي، الذي يُعيد تعريف الاحتلال كواقع طبيعي ويحوّل المقاومة إلى خلل في النظام.
من التاريخ إلى الفلسفة السياسية
إن قراءة كتاب موشيه معوز اليوم، بعد عقود على صدوره، تمنحنا نافذة على العقل “الإسرائيلي” كما تراه المؤسسة الأكاديمية؛ عقل يحاول عقلنة السيطرة، وتحويل المأساة إلى قضية إدارة نزاع، لكنّ هذا المنظور يفشل في إدراك أن ما يفصل سورية عن “إسرائيل” ليس فقط الحدود، بل اختلاف الرؤية للعالم.
“إسرائيل”، في جوهر مشروعها، هي دولة تأسست على فكرة الخوف من الآخر، أما سورية، رغم تناقضاتها الداخلية الحالية، فبنت هويتها على فكرة الصمود أمام هذا الآخر، وهنا يتحول النزاع إلى صراع وجود رمزي لا تنهيه المعاهدات ولا المؤتمرات.
سلام بلا ذاكرة هو حرب مؤجلة
كتاب “سورية وإسرائيل من الحرب إلى صناعة السلام” ليس مجرد دراسة في العلاقات الدولية، بل وثيقة عن لحظةٍ حاول فيها التاريخ أن يتحول إلى إدارة سياسية، ومع ذلك، فإن كل صناعة سلام لا تعترف بعمق الجرح الإنساني محكوم عليها بالفشل.
فالسلام لا يُصنع كما تُصنع الأسلحة أو الاتفاقيات، بل يُبنى على إعادة تعريف الذات في مواجهة الآخر، وسورية، كما يبدو من هذا الكتاب، لم ترفض السلام لكونها ضدّه، بل لأنها رفضت أن يكون سلاما على المقاس “الإسرائيلي”.
إن فلسفة السياسة التي يمكن أن نخرج بها من قراءة معوز، هي أن الاستقرار الحقيقي في الشرق الأوسط لن يولد من موازين القوة، بل من إعادة تعريف العدالة ذاتها وتحديد الهوية.
تحليل كتاب: “سورية وإسرائيل: من الحرب إلى صناعة السلام”
نظرة عامة على أطروحة الكتاب
النقاط الرئيسية:
- الكتاب يحلل العلاقات السورية-الإسرائيلية من منظور أكاديمي إسرائيلي
- يركز على تطور الصراع من نزاع حدودي إلى صراع بين مشروعين قوميين
- يقترح أن السلام يمكن “تصنيعه” كمنتج سياسي وليس نتيجة للمصالحة الأخلاقية
تحليل المنهجية والنقد
المنظور الإسرائيلي (معوز)
- الصراع نزاع على النظام الإقليمي وليس على الوجود
- دمشق ترفض الاعتراف بإسرائيل للحفاظ على النظام العربي
- إسرائيل تسعى للأمن والاستقرار
- السلام منتج سياسي قابل للتسويق
المنظور السوري (ضمني)
- الصراع يتعلق بالوجود والهوية والكرامة
- الاعتراف يعني قبيل الهيمنة الإسرائيلية
- إسرائيل مشروع استعماري توسعي
- السلام يجب أن يقوم على العدالة والكرامة
النقد المركزي
- الكتاب يغفل البعد الكولونيالي لتأسيس إسرائيل
- يحول الصراع إلى مشكلة إدراك وليس قضية استعمار
- يفصل السياسة عن الأخلاق والذاكرة التاريخية
- “صناعة السلام” تعيد إنتاج الهيمنة تحت مسمى الواقعية
تحليل الحروب بين سورية وإسرائيل
تفسير الحروب حسب معوز مقابل النقد:
- 1948: معوز: صدمة وجودية – النقد: بداية الصراع الاستعماري
- 1967: معوز: تعميق الجرح – النقد: احتلال واستعمار
- 1973: معوز: تحول من حرب التحرير إلى حرب التوازن – النقد: محاولة استعادة الكرامة
مفهوم “صناعة السلام” مقابل “بناء السلام”
الفرق الجوهري بين المفهومين:
- صناعة السلام: منتج سياسي، صفقة واقعية، هندسة للهيمنة، يغفل البعد الأخلاقي
- بناء السلام: عملية تحولية، مصالحة الذاكرات، يقوم على العدالة، يعترف بالجرح التاريخي
الاستنتاجات الرئيسية
الدروس المستفادة من تحليل الكتاب:
- السلام الحقيقي لا يولد من موازين القوة بل من إعادة تعريف العدالة
- لا يمكن صناعة سلام على أرض محتلة دون الاعتراف بجذر المأساة
- الذاكرة غير المؤولة تصبح أداة للعنف (بول ريكور)
- الصراع ليس مجرد خلاف حدودي بل اختلاف في الرؤية للعالم

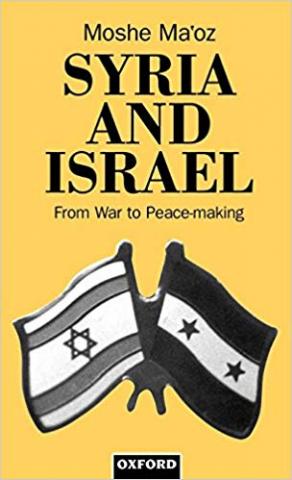

في عرضكم للكتاب، لم تذكروا تاريخ إصدار الكتاب