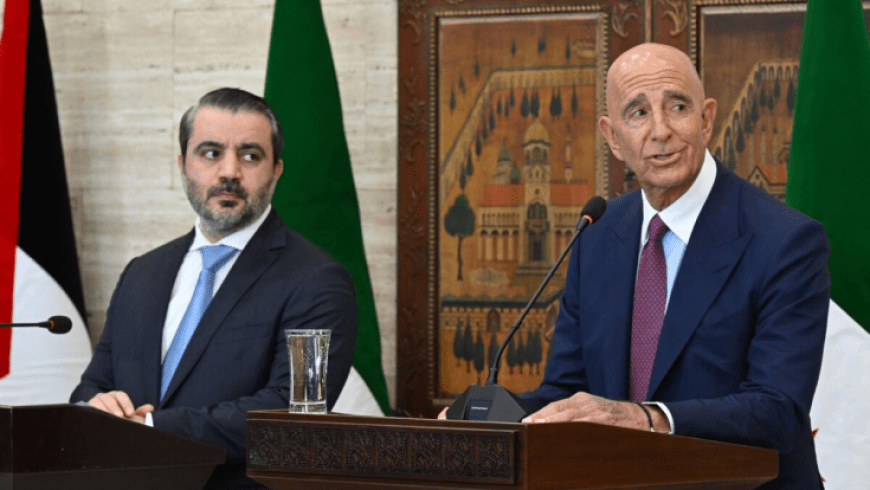في المشهد السوري اليوم يشكل الاتفاق الأمني مع “إسرائيل” نقطة حساسة في صياغة علاقات سوريا الداخلية والخارجية، فهو اتفاق يستدعي بالضرورة مقارنات مع تجارب سابقة، لعل أبرزها اتفاقية فصل القوات لعام 1974، واتفاق الهدنة لعام 1949 الذي أنهى القتال المباشر بعد حرب فلسطين.
رغم اختلاف السياقات التاريخية والسياسية، فإن ما يُطرح حاليا يبدو أقرب في شكله ومضمونه إلى اتفاقية عام 1949، أكثر مما هو امتداد لترتيبات 1974 التي جاءت بعد حرب كبرى، هدفت إلى منع الاشتباك عبر ترتيبات دقيقة في جغرافيا الجولان المعقدة، وخلقت نوعا من التوازن في توزع القوات على طرفي الخط الأخضر.
أما الاتفاق الجديد وفق ما رشح من بنوده فيكرّس واقعا مغايرا، إذ يترك مساحات واسعة من الجنوب السوري، وخصوصا في محافظة القنيطرة وريف درعا، في حالة “فراغ عسكري” شبه كامل من الجانب السوري.
مناطق رمادية وتاريخ متكرر
هذا الأمر يعيد إلى الأذهان ما نصت عليه اتفاقية 1949 حين أوجدت مناطق منزوعة السلاح، وإن كانت محدودة نسبيا، لكنها حملت في طياتها بذور توتر استراتيجي لم يلبث أن انفجر لاحقا، فرغم الإقرار بوقف إطلاق النار، ظلّت تلك المناطق بؤرا للاشتباك والتوتر، لأنها لم تُحدد بدقة مرجعية النشاط المدني فيها، ولأنها تحولت إلى مناطق رمادية بين السيادة السورية والتطلعات الإسرائيلية.
النتيجة كانت سلسلة من المناوشات التي قادت في النهاية إلى حرب عام 1967، التي غيّرت ملامح المنطقة برمتها، واليوم، تبدو “إسرائيل” أكثر تركيزا على هذا التاريخ، إذ تسعى لتضمين الاتفاق المرتقب بندا يتعلق بالنشاط الجوي فوق الأجواء السورية، في محاولة لشلّ أي قدرة عسكرية سورية مستقبلية، رغم أن دمشق لا تملك عملياً اليوم قوة جوية فاعلة.

الغطاء السياسي ومعادلات النفوذ
إن التفاصيل العسكرية للاتفاق ليست سوى غطاء سياسي لإعادة صياغة معادلات النفوذ، فالمسألة لم تعد تتعلق بترتيبات حدودية أو أمنية فحسب، بل بانكشاف كامل للجنوب السوري أمام “إسرائيل”، وبإعادة هندسة الجغرافيا السياسية الداخلية لسوريا، فالاتفاق، إذا ما جرى تطبيقه كما سُرب، سيُخرج فعليا ثلاث محافظات من دائرة التحكم السيادي المباشر لوزارتي الدفاع والداخلية، ويضعها في حالة فراغ مؤسسي تُفضي إلى ديناميات داخلية جديدة.
الشرط الإسرائيلي ليس مجرد مطلب أمني؛ بل مشروع سياسي لتفكيك سوريا من الداخل، وإعادة رسم علاقتها بنفسها قبل أن يعيد صياغة علاقتها بجوارها، فبدل أن يكون الهدف تقسيم البلاد جغرافيا، تسعى “إسرائيل” إلى إحداث تفكك في بنيتها السياسية، بحيث تتحول دمشق إلى مركز ضيق للقرار، محاصر شمالا وجنوبا، ومجرد من أي عمق جغرافي يمكن أن يمدها بقدرة تفاوضية أو قوة ردع؛ إنها محاولة لدفع الدولة السورية إلى الانكماش شمالا، بحيث تصبح عاصمتها على تماس مباشر مع التحديات الأمنية والعسكرية.
تداعيات داخلية محتملة
الأخطر من ذلك، أن الاتفاق يفتح الباب أمام تشوهات سياسية داخلية جديدة، فمع وجود فراغ في ثلاث محافظات، ستنشأ ترتيبات محلية أو شبه فيدرالية، تفرضها وقائع الأرض أكثر مما تفرضها نصوص الدستور، وهذا يعيد إلى الواجهة التناقض القديم–الجديد بين المركزية التي سعت الدولة السورية لترسيخها، والنزعات اللامركزية أو الفيدرالية التي حاولت قوى دولية وإقليمية تغذيتها.
وسط هذا التوازن المختل، يمكن لأي اتفاق أمني مع “إسرائيل” أن يتحول إلى أداة لإعادة تشكيل الداخل السوري بما يخدم مصالح الخارج.
البعد الاقتصادي والجغرافي
من منظور إستراتيجي أوسع، فإن هذه الترتيبات الأمنية لا تنفصل عن الجغرافيا الاقتصادية، فخلق فراغ جغرافي–عسكري في الجنوب السوري يعني عمليا عزل الدولة عن منافذها البرية جنوبا، وفصلها عن عقد المواصلات الإقليمية التي طالما جعلت منها نقطة ارتكاز في المشرق العربي.
هكذا، يصبح الاتفاق الأمني جزءا من مشروع أكبر لإعادة رسم خرائط الممرات الاقتصادية والسياسية في المنطقة، حيث يتم تهميش سوريا وتحويلها من لاعب مركزي إلى طرف ثانوي على هامش التحولات الكبرى.
ما وراء التطبيع
إن إشكالية الاتفاق ليست في “التطبيع” أو الانضمام إلى منظومة “الاتفاقات الإبراهيمية” كما يُسوّق في الخطاب السياسي، بل في جوهره الأعمق حيث يحدد شكل الدولة السورية نفسها، ويضع مستقبلها على المحك، فغياب عقد اجتماعي قادر على إعادة بناء الدولة بعد الحرب، جعل من سوريا ساحة مفتوحة للمساومات الدولية، وسمح لـ”إسرائيل” بأن تطرح شروطها بوصفها قوة إقليمية لا ينازعها أحد، وأي تفاهم أمني اليوم لن يكون مجرد ترتيب لوقف إطلاق نار أو منع اشتباك، بل إعادة إنتاج للدولة على مقاس جديد.
إن ما يجري تداوله اليوم ليس سوى إعادة استحضار لاتفاقية 1949 بشكل جديد، لكن مع فارق أساسي أن “إسرائيل” اليوم لا تواجه جيشا عربياً منهكا خرج من حرب، بل دولة سورية ممزقة، بلا قوة جوية فاعلة، وبلا عقد اجتماعي جامع، وبلا قدرة مؤسسية على فرض سيادتها الكاملة، ما يجعل الاتفاق الأمني مشروعا لإعادة تعريف سوريا لا ككيان جغرافي فحسب، بل كهوية سياسية ومجتمعية.
إن الحديث عن “الأمن” في هذا الاتفاق ليس سوى عنوان عريض لمشروع أعمق، يطال مستقبل سوريا كدولة وكهوية، ويعيد صياغة موقعها في الإقليم.
إنها لحظة فارقة، أشبه بما وصفه روبرت كابلان عن “الجغرافيا كقدر”؛ إذ تتجاوز القضية حدود الاشتباك العسكري لتدخل في صميم تعريف الكيان السياسي السوري ومستقبله.